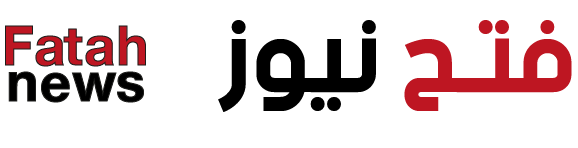الأسرى.. من تفكيك الحَرف إلى الإبداع الأدبي وشهادة الماجستير
وجود قلم وورقة بيد الأسير الفلسطيني في معتقلات الاحتلال الاسرائيلي بعد عام 1967، كلف دماء وارتقاء شهداء في زنازين وساحات السجون، وأمراضا سلبتهم عافيتهم، وغيرت حياتهم الطبيعية، بعد معارك طويلة خاضتها أمعاؤهم الخاوية.
بعد الإضراب الجماعي الرابع عن الطعام في تموز عام 1970، الذي استشهد في يومه السابع “عبد القادر أبو الفحم”، سمحت إدارة السجون بإدخال الأقلام والدفاتر وبعض الكتب عبر الصليب الأحمر، لكن بتقييدات معقدة، أغربها توزيعها صباحا، وإعادتها مساء، فيما قيدت تبادل الرسائل مع ذويهم عبر بطاقات من الصليب الأحمر محددة بخمسة أسطر فقط.
وسرعان ما كانت تُسحب الأقلام والدفاتر من بين أيديهم، عدا عن الرقابة على كل ما يُكتب، والتفتيش اليومي، والمصادرة، وهو ما أضاع مئات الأعمال الأدبية الإبداعية والشخصية للأسرى.
في تلك الفترة، لجأ الأسرى إلى شبه المستحيل، ليحصلوا على القلم، فكان أول ما هربوه “أنبوبة القلم”، عبر زيارات شحيحة ومقيدة للصليب الأحمر، أو المحامي، أو الأهل، لتدور الأنبوبة الرفيعة بين الأقسام، فيما كان بديل الورق هو الأغلفة الفضية التي تغلف السجائر، وأغطية علب اللبن، وكراتين معجون الأسنان، وصابون الحلاقة، والخبز.
الوسيلة الأولى لنقل المكتوب وإلى اليوم كانت “الكبسولة”، وهي ورقة صغيرة مكتوبة بخط رفيع ودقيق، يتم تغليفها بنايلون وبلعها، وإخراجها لحظة تنقلات السجين أو تحرره، حيث خرجت من خلالها عشرات الإصدارات، وعشرات آلاف الرسائل.
في بداية التسعينيات، كتب وسام الرفيدي، في سجني “النقب”، و”نفحة” على كراس كتابه “الأقانيم الثلاثة”، قُسم إلى 54 كبسولة مرت على 6 سجون، قبل أن تصبح خارج الأسوار وتنشر، فيما نامت فصول رواية لخضر محجز ستة أشهر متواصلة في “النقب”، بملابسه الداخلية، خشية مصادرتها.

أما حلمي عنقاوي فقال: عام 1986 كان السجان يطفئ الأنوار عند الساعة 10 مساءً، فأدخل الحمام الذي يبقى مضاءً، لأقرأ.. أخرجت ثلاثة كتب تهريبا عبر زيارات الأهل، فيما صودرت لي دراسة سياسية.
من بساطة هذه المقتنيات، حوّل الأسرى السجون إلى مدارس وجامعات، مئات الكُتاب، والشعراء والفنانين التشكيلين، وأساتذة جامعات، فيما تحول سجن “هداريم” إلى “جامعة هداريم”.
وبحسب دراسة (جامعة السجن في “هداريم”: استِئْلاف الموحِش وفقه البقاء) لقسم الحاج، فإن عدد خريجيها حتى نهاية الفصل الدراسي الأول 2022/2023، (170) لدرجة البكالوريوس، و(176) لدرجة الماجستير، بينما عدد طلاب البكالوريوس 13 طالبا، والماجستير 107 طلاب.
عمل السجّان على عزل الأسير عن العالم، و”تفريغه ثقافيا”، بمنعه من القلم، والورقة، والكتب، والمجلات، والصحف، والمذياع، والتلفاز.
في المحصلة النهائية تم إدخال الدفتر، والقلم، والكتب، في هذه الفترة بدأ محو الأمية، والتعليم المدرسي، ولاحقا الانتساب للجامعة، وتعلم العبرية والانجليزية، وبنسب أقل الفرنسية والاسبانية والروسية، بوجود قواميس وصحف أجنبية. فانتقلت إدارة السجون إلى مصادرة المادة المكتوبة بشكل سري، بخط اليد بعدة نسخ، لتذهب للمخابرات والمتدربين من الضباط، لدراسة الأسرى، ومعرفة كيف يفكرون.
“الثقافة عدو الجلاد”، كما يخبرنا سامي الكيلاني في كتابه “فتح النوافذ الموصدة”: يومها كان العمل في الثقافة “خطيرا”.. وكما كتب عمر نزال في إصداره “كباسيل”: “طوردت أنابيب الأقلام كما تطارد العبوات الناسفة”.
“لست في غرفة ضيقة، أنا أجوب العالم يوميا من خلال قراءاتي”، أجاب الكيلاني، ضابط اسرائيلي استدعاه أواسط الثمانينيات إلى غرفة واسعة مكيفة، ليسأله عن موقفه السياسي.
ويضيف الكيلاني، الذي أصبح بعد تحرره محاضرا جامعيا: “السطر الذي تكتبه ويصادر السجان نسخته الأولى يورثك حزنا من نوع خاص، فتجد كل المحاولات صغيرة في قدرتها على إعادة الأصالة في الخلق الأول”. صودر دفتري الأول، وقصص، وترجمات، ويوميات غرف الأسرى والزنازين، كما فقدت ترجمة “دولة اليهود” لثيودر هرتسل، تلك الدفاتر كانت تعني الكثير بثمنها المعنوي، أو بالأحرى ما دُفع من جوع في إضرابات سابقة ليكون امتلاكها حقا طبيعيا”.

النقل الشفوي للجلسات الثقافية ساهم بإغناء فكر كل أسير على حدة، كما يذكر حاتم اسماعيل الشنار الذي اعتقل من 1969 إلى 1985: “كل أسير تحول إلى كتاب وظاهرة وتجربة منفردة يطالعه زملاؤه، صاروا كتبا، مكتبة بشرية لا تنفد”.
لا بد من الإشارة إلى أن هذه الإنجازات متذبذبة، فالتعليم في “الجامعة العبرية المفتوحة” تعطل لفترة عام 2011، ضمن سلسلة عقوبات على الأسرى، والذين تمكنوا بعد نضال امتد 25 عاما من انتزاع هذا الحقّ، خلال إضراب عام 1992.
خلت المعتقلات حتى بدايات السبعينيات من المكتبات، فكان اعتماد الأسرى على كتابين يحضرهما السجان -غير قيّمة-، فيما فرضت الإدارة من 1967–1985 تشغيل الراديو عبر مكبرات الصوت على محطة الإذاعة الإسرائيلية لساعتين، تبث فيهما نشرتي أخبار وأغنية “لأم كلثوم”، فيما الصحيفة الوحيدة المسموح تصفحها هي “الأنباء” الناطقة باسم الاحتلال، وترافق معها احضار محاضرين من الجامعات العبرية، لصهر وعي الأسير.
خلال إنشاء مكتبات السجون بعد 1972، أصدرت الإدارة قرارا بمنع 600 عنوان من دخول السجون، وفي 1979 سمح بإدخال كتاب واحد شهريا، وفي 1980 سمح بجريدة القدس والصحف العبرية، فيما دخل الراديو والتلفزيون عام 1985.
الشهيد عمر القاسم من أوائل المحاضرين في السجون عام 1969، يروي رفيقه في الأسر خالد الزبدة: كان يحاضر في النسبية لآينشتاين، والتطور لدارون، ونظرية نيوتن، والقوميات، وأصول العائلة لإنجلز، والثورة الروسية والكوبية والصينية والجزائرية والفيتنامية، وثورة سبارتاكوس، وقصص ميخائل نعيمة، وروايات نجيب محفوظ، فيما أصبح الأسرى الذين تعلموا على يد القاسم قادرين على إعطاء المحاضرات.
اعتبر سجن “عسقلان” الذي افتتح عام 1969، بداية الحياة الثقافية في السجون، وفي وقت لاحق شكل “بئر السبع” ثقلا ثقافيا، تلاهما “نفحة”، الذي افتتح عام 1980 كعقاب للقيادات والنخب، وإذ به يتحول لقلعة فكرية.
أصدر الأسرى العديد من المجلات الأدبية والسياسية، منها: “القدس” سجن بئر السبع 1979، “الهدف الأدبي” سجن عسقلان 1981، “الصمود الأدبي” سجن عسقلان 1986، “صدى نفحة” سجن نفحة 1989، “إبداع نفحة” نفحة 1990. “النهضة”، “راية الشعب” سجن عسقلان، “الشهيد موسى حنفي” سجن جنيد.
ما بين 1984-1985، صنع عوني الخروبي آلة “الكمان”، في “عسقلان”، و”نفحة”، و”غزة”، فكانت الإدارة تعاقبه بزجه في الزنازين، كلما ألقت القبض على آلة موسيقية بدائية كان يصنعها من التمديدات الكهربائية وطاولات الزهر.
عام 2010 صنع فداء الشاعر ووليد دقة “عودا” من الأرز الذي جرى تحويله إلى غراء، وغطاء المعلبات لنشر خشب طاولات الشطرنج والزهر، ومن ملاعق الطهي الخشبية صنعت مفاتيح، ومن المكنسة الخشبية بيت المفاتيح وزند العود، وأوتار مهربة بملابس نوم خلال زيارة الأهل، كُتبت قصائد مغناة، وأشعار ذاقت اللحن على العود، قبل اكتشاف أمره، ليودع الشاعر ودقة الزنازين.
بالعودة إلى تحول “هداريم” إلى جامعة، فكرة ورئاسة الدكتور مروان البرغوثي، حيث ضم نخبة ثقافية، وفكرية، وأكاديمية، كوليد دقة، وكريم يونس، وناصر أبو سرور، وحسام شاهين، وياسر أبو بكر، وعاهد أبو غلمة، وأحمد سعدات، وغيرهم..، والذين درسوا المساقات بنظام صارم يطبق القواعد الأكاديمية بأدق المعايير والمهنية.
يقول الأسير رائد الشافعي: “التعليم هو المعول الوحيد والقادر على هدم الغاية من السجون، واستبدال رقم الأسير الذي وجد لمسح الذات وإلغائها، الى رقم جامعي لدرجة البكالوريوس والماجستير، للحفاظ على القيمة الإنسانية، واعادة التوازن النفسي للأسير”.
انطلقت جامعة “هداريم” أوائل 2012 بمنح الماجستير في تخصص الدراسات الإسرائيلية- فرع الدراسات الإقليمية، وبعد تخريج الدفعة الأولى عام 2014، تم الشروع ببرنامج البكالوريوس في العلوم السياسية، وبكالوريوس التاريخ من جامعة القدس المفتوحة في معظم السجون.
تعرض “هداريم” عام 2018 لـ”مجزرة كتب”، صودر خلالها 3000 كتاب، وعزل مروان البرغوثي لأكثر من مرة في الزنازين، فيما نُقل العديد من حملة الماجستير والهيئة التدريسية إلى سجون أخرى، لكنهم تحولوا إلى رُسل لحمل الرسالة التعليمية للسجون التي انتقلوا إليها.
إضافة لشح المصادر والمراجع، وعدم توفر تكنولوجيا تسهل على الباحثين والدارسين، كان الأسرى ينسخون مساقاتهم وأبحاثهم باليد، وكثيرا ما تعرض جهدهم للمصادرة.
ابتدع الأسرى طرقا لتبادل الكتب والكراسات والرسائل فكانت المرافق العامة للسجون بريدهم، كالمطبخ والمغسلة والعيادة. “ففي 1972 حصلت أسيرات سجن “نفي تريستا” على مجموعة كتب بعد نقل ثلاثة منهن إلى سجن نابلس لمدة 8 أشهر، حيث تمكّن من الحصول عليها عبر المغسلة، والعودة بها تهريبا”. عائشة عودة/ كتاب “كباسيل”.
من تجربة 14 عاما ونصف في السجون، يقول علي جرادات: “في السجن رغم الحصار الفيزيائي يمكن أن تعيش حرا إن استغللت كل النوافذ المتاحة لتطوير نفسك، أهمها الكتاب”.
نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”