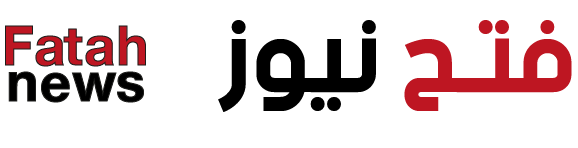هكذا يفقد الفلسطينيون الصبر والأمل
في 22 أيار 2024 يكرر محمد أبو مطاوع أمام مجموعة من الرجال في مبنى المجلس القروي لعين البيضا أقصى شمال شرق الضفة الغربية بحماس، “اقترب موسم البطيخ”، رغم ما واجهه هذا الفصل الزراعي من صدمات يومية منذ أشهر.
كان ارتفاع درجات الحرارة، وعدم انتظام هطول الأمطار، واستحالة بناء السدود في منطقة الأغوار، وطرائق الري التي عفا عليها الزمن، سببا بانخفاض حاد في كمية المياه في السنوات الماضية، لكن الوضع الخطير الناجم عن تلك العوامل، أصبح أكثر حرجا اليوم، بسبب ضغط المستعمرين المتواصل.
لاستخراج المياه كي يروي أبو مطاوع أرضه في منطقة “خربة الدير”، أصبح بحاجة إلى تجميع مياه الينابيع في حاويات إسمنتية وأخرى ترابية حول النبع، حيث تحولت إلى نقطة صراع مرير اليوم مع المستعمرين، الذين يستخدمونها للسباحة.
عاش الفلسطينيون هنا مرة باسم مزارعي القمح، ثم بوصفهم رعاة البقر البلدي، ثم في السنوات الأخيرة ملوك مزارعي البطيخ والخيار القزمي “البيبي”، واختار الكثيرون منهم هذه الأعمال بشجاعة وتصميم عندما لم تكن ندرة السكان والفراغ الجغرافي القاتل للدولة المستقلة القادمة سائدين كما هو اليوم.
هكذا يمكن رواية سيرة حياة هذه المنطقة، قبل دخول الحسابات العنصرية التي أخذت بالظهور مع بداية الاستعمار الإسرائيلي بعد عام 1967، ووصلت ذروتها خلال الأشهر القليلة الماضية.
بدأ أبو مطاوع منذ أشهر يخسر نبعا تلو الآخر، وقال لمراسل “وفا”: “أخذوا 10 ينابيع، في البداية وضعوا أرجوحات حولها، ثم استولوا على مضخات المياه ورموها بالماء”.
“إحباط إلى حد الانهيار”
هناك شيء مخيف للغاية يجري شرق الضفة الغربية. كان يُفترض أن يكون هذا جيل الأمل من الفلسطينيين الذين يجنون ثمار اتفاق أوسلو عندما كان يقود احتمالا للخلاص من الاحتلال.
منذ بداية عام 2023، تغير كل شيء بالنسبة إلى محمد أبو مطاوع وأهالي المنطقة، وفي نهايته، شنت إسرائيل حربا على غزة وأخرى صامتة في الضفة الغربية عنوانها الدفع إلى تغيير الوضع الديموغرافي شرق الضفة الغربية.
إن مثال ما يواجهه المزارعون هنا على طول الشريط الغوري الضيق شرق الضفة الغربية، أكبر إشارة على انهيار الآمال وفقدان الأرض.
عند ظهيرة يوم 22 أيار 2024، ركن محمد أبو مطاوع إلى زاوية في مسكن هو أقرب مساكن الفلسطينيين إلى نهر الأردن، وبطريقته المميزة في الحديث، بذراعين مطويتين، ورأس تتحرك باستمرار، سرد قصته مع الصراع اليومي الذي يخوضه في محيط الينابيع، لكنه لم يغفل عما قد يجري في الخارج، فيما إذا عاد المســتعمرون فجأة إلى الينابيع.
أبو مطاوع، من كبار المزارعين هنا، ومهما حاول هو وغيره من المزارعين إخفاء حقيقة، أنهم خائفون من المستقبل، إلا أن ذلك يظهر في حديثهم لاحقا.
لم يكن المزارعون يملكون العزيمة على إنتاج أفضل أصناف البطيخ والخضراوات والفواكه الأخرى فقط، بل كان لديهم كل الفرص لإدخال مزيد من الزراعات الجديدة.
كان أبو مطاوع شجاعا وخبيرا إلى حد كبير، عندما زرع مساحات واسعة من الأراضي في السنوات الأخيرة، لكن مستقبله الآن في مهب رياح عاتية تقتلع كل شيء أمامها.
“استيطان العلم”
تبدو شهادات الناس مقسمة إلى عدة أجزاء، الأول الخوف من الطرد، والتالي الخوف من الاعتداء، والجزء الأحدث هو الخوف من الأعلام الإسرائيلية.
وأطلق الناشط الحقوقي عارف دراغمة، على هذه الطريقة الجديدة للاستيلاء على الأرض، اسم “استيطان العلم”، وتتلخص ببساطة في وضع المستعمرين سارية طويلة عليها “علم دولة الاحتلال” في المناطق الرعوية أو ساحات المنازل التي يصلون إليها، وبعد فترة يسيّجون المنطقة أو يستولون على جبل أو تلة.
على بعد نحو 15 كم من طوباس شمال الضفة، تظهر أعلام كثيرة مزروعة في مناطق فارغة وأيضا في ساحات منازل المواطنين، وفي الأيام الأخيرة وضع المستعمرون علما على تل أثري يسمى “تل الحمة”، قال دراغمة.
تُعتبر عملية الاستيلاء على الأرض بوساطة العلم من أوضح الأمثلة على الخسارات الكبيرة التي يخسرها الفلسطينيون من الأرض يوما بعد يوم.
يحاول الفلسطينيون الابتعاد عن الأعلام خوفا من أن توقعها الرياح ويُتهموا بإيقاعها ويدفعوا لاحقا ثمنا باهضا عندما يصل المستعمرون في اليوم التالي، ويهددون بالقتل والخراب.
على بعد كيلومترات قليلة عند مفترق طرق يجمع بين طريقين رئيسيين، واحد يقود إلى نابلس، والثاني إلى طوباس، أشار أحد الرعاة، إلى أنه يتجنب المرور من جانب العلم، خوفا من اتهامه بإيقاعه.
“واد المالح”.. لم يتبقَّ منه إلا اسمه:
هنا سلسلة جبال على اليسار، وأخرى على اليمين، وفي الوسط وادٍ جاف لم يتبقَّ منه إلا اسمه: المالح، في هذه المنطقة تحدث واحدة من أكثر التغيرات السريعة فوق الأرض الفلسطينية.
كان التل من قبل ينحني جانبيا وإلى الخلف، لكنه الآن أصبح أكثر انبساطا، بعد أن طوقه المستعمرون بسياج شائك، ومحوا سنة بعد سنة آثار طبيعة البكر بفعل عمليات تجريف استمرت أشهرا، قبل أن يشيّدوا فوقها مباني ضخمة.
حُشدت الأعلام في منطقة وادي المالح حول هذه الأبنية الاستعمارية الجديدة، وأمام معظم التجمعات الفلسطينية هناك، ووُضعت في ساحات المساكن الترابية وعلى قمم التلال والجبال، فأصبحت الجغرافيا تحت السيطرة الإسرائيلية بسارية وقطعة قماش.
إذا كان المشهد اليوم يشير إلى سيطرة مطلقة للمستعمرين في هذه المنطقة، فإن المستقبل بالنسبة إلى سكان الوادي أصبح مشكوكا فيه، فجميعهم يطرحون سؤالا واحدا: إلى أين نذهب عندما يطردوننا؟.
في فترة زمنية قصيرة، وعلى مسافة يمكن قطعها بمركبة تسير بسرعة متوسطة خلال أقل من ساعة، يمكن مشاهدة التغيرات التي تولد بسرعة هنا!.
مبانٍ استعمارية جديدة ومناطق تتم السيطرة عليها وتسييجها يوميا، وممرات صغيرة تشق للمسير اليومي والربط بين المستعمرات والبؤر الجديدة، وحدائق جديدة تجهز.
انه”الزمن الذهبي للاستيطان”.
أربعة مستعمرين استولوا في وضح النهار على نبع قريب من مزرعة أبو مطاوع، هذه المرة ليس إلا بهدف السباحة، وهذا يبشر بالسوء في المستقبل القريب.
“هكذا بدأت المضايقات في مناطق عديدة من شرق الضفة الغربية، بسياسة ناعمة في البداية، تنتهي بترحيل مئات الفلسطينيين عن أطراف مصادر الماء التي صارت تحت سيطرة المستعمرين”، قال الناشط دراغمة.
وفي ظلال هذا التغير، ضعفت الركائز الأساسية للوجود الفلسطيني بشكل واضح، وترك الكثير من الأهالي مناطق سكناهم، وتشردوا إما داخل الأغوار نفسها، أو رحلوا إلى مناطق قريبة من المدن الفلسطينية مثل طوباس ورام الله وأريحا.
لا يحتاج أبو مطاوع إلى إثبات ما يجري يوميا، فكل هذه الندب التي ظهرت في حياتهم وتحدث عنها كانت واضحة في الشهادات التي أدلى بها سكان الشريط الغوري وحتى أطراف المرتفعات القريبة من نابلس ورام الله، المدينتين الكبيرتين بثقلهما السكاني والاقتصادي.
ماذا جرى منذ السابع من أكتوبر؟
الكثير من الأسباب التي خلخلت أساس التجمعات الرعوية المستقرة منذ سنوات، قد نتجت عن قرارات تم اتخاذها في غرف رسمية إسرائيلية وقواعد عسكرية، كالطلب من الرعاة الرحيل بقرارات “قضائية”، وأخرى عسكرية إسرائيلية لم تمنحهم سوى وقت قصير لتنفيذها.
بالقرب من واجهة الحدود الشرقية في منطقة الفارسية وهي ضمن منطقة وادي المالح، حفر المستعمرون جبلا فوق مساكن الأهالي وأقاموا حيا استعماريا جديدا.
المستعمرون لم يعودوا يفرقون بين من يسكن بالقرب منهم أو على مبعدة، فهم يخرجون من مستعمراتهم يهاجمون ويحرقون ويطلقون النار، وخلال ساعة أو أكثر تنتهي العملية بخسران سكان القرى منازلهم ومركباتهم وحقولهم، لكن كلما اقترب الفلسطيني من مصدر المياه، كانت درجة الخطورة أعلى.
قال أحد سكان الفارسية، إن هناك قواعد جديدة للحركة “إذا هرب كلبك بعيدا فلا تلحقه”. وهو يشير بذلك إلى تقييد حرية حركتهم من قبل المستعمرين.
ماذا جرى منذ أكتوبر؟ سألنا بعض الرعاة في حقول فيها قش مُتيبّس وبعضها مزروع بالخضراوات؟. أجابوا: أنهم يقضون أصعب الأيام.
وبحسب شهادات للسكان – لا يصرحون بأسمائهم خوفا من ملاحقة المستعمرين- “هناك مجموعات مختلفة من المستعمرين أخذت على عاتقها الضغط على السكان للرحيل، ووصل الأمر بهم إلى التهديد بالذبح والقتل.
عائلة عبد ربه المكونة من 7 أفراد، لاحظت مؤخرا نفوق عدد من مواشيها تباعا، ولاحقا اكتشفت نوعا من السموم يدعى “سفسان” يشبه قطع العلف الأسطوانية الصغيرة، وضعه المستعمرون أمام المواشي في المراعي.
يسكن مصعب عبد ربه (17 عاما)، مع عائلته في خربة الدير وهي أقرب تجمع فلسطيني إلى نهر الأردن، حيث عاد الفلسطينيون للسكن فيها قبل أكثر من عقد، بعد أن دمرتها قوات الاحتلال عام 1967 ورحل سكانها، وتضم الآن 8 عائلات.
قال مصعب”تملك عائلتي قطيعا يناهز 300 رأس من الأغنام البيضاء. ولم تكن هذه أول محاولة لدفعنا إلى الرحيل من هنا. لكنها كانت البداية”.
في طريق ترابي وملتوي بين حقول الذرة وبيارات الحمضيات، ظهر صف من ألواح الكهرباء الشمسية وقد حطمها المستعمرون فأصبحت خارج الخدمة.
بعيدا عن النسخ المتشابهة من الشهادات التي يدلي بها المتضررون من هجمات المستعمرين، تظهر قصة مصعب نسخة خارج السياق من العذاب الذي يواجهه الفلسطينيون هناك.
قبل شهرين، كان مصعب واثنان من أشقائه على بعد 3 كم من منزلهم، يتواجدون في المراعي الخصبة، فجاء مستعمرون بمركباتهم بحماية قوات الاحتلال، يصرخون ويهددون، فخاف قطيع المواشي ولجأ إلى أحد الأودية الانهدامية في المكان، حيث انهار فوقه فنفق عدد منها.
طبيعة الأرض في تلك المنطقة رمادية اللون ورخوة التكوين، وسريعة الانهيار، كما كل شيء هنا: معنويات الناس واقتصادهم وأحلامهم وأرضهم.
تغيرات سريعة ومروعة:
يصف رئيس المجلس القروي في عين البيضا عمر فقهاء، وهي القرية الزراعية الصغيرة والوحيدة في الضفة التي تقع خلف الطريق الذي يحمل اسم “طريق 90″، التغيرات التي يشهدها محيط قريته، بالسريعة والمروعة.
وقال إن “الخوف من المستقبل يدفع الناس إلى الخروج. هذه خطتهم للتجهير”. تشهد عين البيضا أكثر مناطق الاحتكاك الجغرافي مع المستعمرين تطويرا مستمرا في مرافقها وشوارعها وأبنيتها العامة.
بعض المواطنين الذين تم الاعتداء عليهم، خسروا ممتلكاتهم الخاصة، وآخرون هددوا بالقتل إذا لم يرحلوا، وبعضهم بقي في مكانه ولم يرحل، لكن هذا لا يعني أن من اعتدى عليهم بقوا في مكانهم طوعا، لكنهم لم يجدوا حتى الآن مكانا مناسبا لهم.
في ليلة 28 أيار 2024، تسلل مستعمرون إلى الفارسية مرة أخرى والهدف لم يكن معروفا حتى تلاشي الظلام، في الصباح، لم يجد شامخ دراغمة صهريج المياه الخاص به، فأبلغ عن سرقته، بعد ساعات التقط ناشط حقوقي صورة للصهريج داخل مزرعة أحد المستعمرين على بعد عشرات الأمتار من مكان السرقة.
بدأ المستعمرون، الذين حصل بعضهم على أسلحة رشاشة، بفضل قرار الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بتدمير وتخريب كل ما يقف أمامهم من مزارع وحظائر وأيضا مساكن فارهة في عمق الضفة الغربية كما حدث في ترمسعيا والمغير قرب رام الله.
وعلى مدار الأشهر التالية، أشعل المستعمرون النار في آلاف الدونمات الزراعية ودمروا مركبات وأجبروا المئات من المواطنين على الرحيل عن منازلهم.
يستخدم الأهالي في الأغوار هذه الوسيلة الاجتماعية الرقمية “التصوير” لتحذير بعضهم البعض في ذروة الهجمات، فتوفر أجهزة الاتصال والإنترنت، يجعل من التحذير من هجوم المستعمرين ممكنا وسريعا، وهذا جنبهم الكثير من الأضرار اليومية.
“بقايا ذكريات”
عندما اجتاح المستعمرون القواعد الزراعية والحضرية بشكل ظاهر بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وجد عبد الرحمن الكعابنة نفسه يعيش كابوساً.
إنها معجزة، فكيف نجت عشيرة الكعبانة من الهجوم الكبير على قريتهم وادي السيق في 12 أكتوبر 2023، كانت الخاتمة المأساوية قيد الإعداد لمصير سكان التجمع.
وقال عبد الرحمن الكعابنة” الساعة 12:30 ظهرا، وصل المستعمرون إلى القرية وهددونا بالذبح وارتكاب مجزرة كبيرة(..)، أخرجنا النساء والأطفال إلى أطراف قرية رامون، والليلة التالية عشنا الجحيم. فقد هاجمونا من كل الاتجاهات بحماية الجيش وضربوا الجميع. الكل تعرض للضرب”.
وادي السيق تجمع رعوي زراعي مكون من ثلاث حارات يقع بين رام الله وأريحا، وفي تلك الليلة هوجمت الحارات الثلاث وأُجبر أهلها على الرحيل قسرا، واليوم يعيشون في أطراف قرية رامون.
يحاول الكعابنة الاحتفاظ بذكريات ما قبل ذلك الهجوم. ويحاول اليوم من بعيد النظر إلى المنزل الذي سكن فيه عشرات السنين ورعى نحو 400 رأس من الغنم، فقد تمت إزالة رموز الحياة هناك مثل المراعي والمزارع، وتبقّت بقايا ذكريات الماضي، إلا أن القصة لم تنتهِ.
ففي نهاية يوم 29 أيار، وقف الكعابنة أمام مسكنه الجديد بعد التهجير، وشاهد امتداد العمل الاستعماري نحو الجبال العالية القريبة من أطراف محافظة رام الله.
رغم أن بعض السكان في التجمعات الرعوية يحاولون أحيانا تلطيف الكلمات التي يستخدمونها خلال إعطائهم إفادات عن حياتهم اليومية، إلا أن الحقيقة الظاهرة تظهر خلاف ذلك، فالسيطرة على الأراضي الرعوية الفارغة من قبل المستعمرين تزداد يوما بعد يوم.
طوق عسكري يخنق شرق الضفة
توضح المنشورات الصباحية المقرونة بصورة يومية للناشط دراغمة، الحال الحقيقي للطوق العسكري حول شرق الضفة الغربية: صف طويل من المركبات تنتظر عند مدخلين هما الحمرا وتياسير، وفي كل اتجاه يحاول السائقون العبور ببطء إلى منطقة الأغوار.
لقد اختفت تلك النشوة التي كانت تغلف أحاديث المزارعين بجني أرباح نهاية العام مع تزايد وضوح التغيرات التي تضرب المنطقة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
كانت الساعة تقترب من الثانية عشرة ظهرا، عندما اجتمع عبد ربه وأبو مطاوع في غرفة من قصدير وخيش وتحدثوا عن آلام الحياة وسعادتها.
في محيط المسكن الذي جلسا فيه، مناطق مظللة بأغصان الأشجار ونسيم دافئ يهب من الشمال ويعكس جوا منعشا بداية الصيف، لكن فقدان الأمل بالمستقبل غلف كل الحديث. عندما سئل عبد ربه عن المستقبل انفرجت شفتاه عن ابتسامة اختلطت فيها السخرية مع عدم اليقين.
حدثت أكبر خسارة للأراضي في الأشهر الماضية بمنطقة وادي الفيران في الأغوار، وقدر الناشط دراغمة مساحة الأرض التي سيّجها المستعمرون بـ60 ألف دونم، وهي الآن مراعٍ لأبقار المستعمرين أو مناطق مغلقة تماما في وجه الفلسطينيين.
هناك علاقة وثيقة دائما بين وجود مصادر المياه واستقرار المزارعين الفلسطينيين، لذا عندما مُنع الفلسطينيون من الحصول على الماء ونقله، رحلوا من كثير من المناطق، قال دراغمة.
عندما يأتي الصيف تعود أزمة المياه وتبدأ الصهاريج بنقلها من القرى الزراعية إلى التجمعات الرعوية، وجهة هذه الرحلات اليومية معروفة في السابق، فقد كانت الينابيع التي سيطر عليها المستعمرون، أما الآن فهي بعض أنابيب المياه الزراعية التي على قلتها قد تقدم الحد الأدنى من الماء للمزارعين.
“التهجير تحت ستار الحرب”
“التهجير تحت ستار الحرب”، صفحة خاصة، أطلقها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة “بيتسيلم”، لرصد عمليات التهجير القسري. وحتى 17 نيسان الماضي، رصد محققو المركز تهجير 1056 فلسطينيا من 18 تجمعا فلسطينيا في الضفة.
إن تقييم ما يحدث يوميا أكثر درامية من مجرد النظر إلى عمليات التهجير والاستيلاء على الأرض، كحالات عامة معزولة في مناطق محددة، لذلك تظهر مقاطع الفيديو التي تُبث يوميا وتُرصد فيها هجمات المستعمرين أكثر سوداوية من الأرقام.
وعادة لا يتطلب الأمر سوى دقائق قليلة لتظهر نتائج عمليات التخريب. عندما سرق صهريج شامخ دراغمة من منطقة الفارسية لم يتطلب الأمر سوى ساعات معدودة حتى كشفت وسائل التواصل الاجتماعي المكان الذي نُقل إليه داخل حدود المستعمرة المجاورة.
بعد منتصف ليل الجمعة 24 أيار، هاجم مستعمرون حظائر أغنام مملوكة لعرب المليحات لسرقة مواشيهم، مستغلين غموض الليل. تلك الليلة أفاقت عالية المليحات على صوت رنين هاتفها النقال، عندما اتصل أحد أبناء عمومتها بالعائلة ليخبرهم بأن المستعمرين يهاجمون ويسرقون.
عالية (27 عاما) وُلدت وعاشت في هذا التجمع، وخلال السنوات الماضية حصلت على اللقب الجامعي الأول في الإدارة الصحية، لكنها الآن أحد الوجوه المعروفة لرصد ما يجري هناك، إنه نوع آخر من الرصد، يعتمد على التصوير لكل ما يجري، وبالتعاون مع جمعيات حقوقية تقول الفتاة، إنها استطاعت أن تنقل قصة عشيرتها إلى العالم.
حسن المليحات المشرف على منظمة محلية للدفاع عن البدو، رصد تلك الوقائع، وقال: إن ليلة واحدة أو يوما واحدا قد يشملان ثلاثة اعتداءات تنطلق من ثلاث مستعمرات تحيط بعائلة المليحات التي تسكن عند منتصف المرتفعات الجبلية، التي تطل على أريحا من الغرب ورام الله من الشرق.
روى المليحات كيف تدفع 60 عائلة فلسطينية يوميا ثمن وجودها فوق ما وصفه بـ”صفيح من النار”.
عالية شهدت هجمات كثيرة للمستعمرين، وفي إحدى المرات هوجمت هي ذاتها بينما كانت تعمل داخل المنزل هي وأخواتها ووالدتها، اللواتي استطعن دفع مســـتعمر وصل إلى ســـاحة مســــكنهن، مدعيا أنه يبحــث عن أغنام له.
يفيد الأهالي بوجود فرقة خيالة شكلها المستعمرون لمهاجمة تلك التجمعات، وصلت إلى عرب المليحات بعد أربعة أيام من هجوم الفجر وطاردت المواطنين لأكثر من ساعة قبل أن تنسحب.
لدى كل فرد من المليحات روايته الخاصة عما يجري على الأرض، لدرجة يصعب أحيانا تفريقها عن بعضها البعض إلا من خلال اسم راويها.
محمد المليحات أحد الوجوه الشابة المعروفة وسط هذا التجمع، يروي تفاصيل هجوم تعرض له مسكن زوج شقيقته وعائلته، وقال: “قبل عدة أشهر عندما كانوا يجلسون مطمئنين في منزلهم، وصل مستعمر إلى داخل حظيرة المواشي خاصتهم، وتصادم معهم قبل أن يطلق النار في الهواء، ويستدعي عددا كبيرا من المستعمرين، وبعد نصف ساعة وصلت شرطة الاحتلال إلى المكان، وادعى المهاجم أنه يبحث عن ماشية له”.
يتصل الناس هنا ببعضهم البعض لتناقل ما يجري من أحداث ويدافعون عن وجودهم، لكن أحدا لا يعرف إلى متى يستمر هذا الوجود؟.
قال محمد، “نحن نقف وحدنا عزلا أمام جيش مسلح”. على مدار سنوات تصدى المليحات وغيرهم في المنطقة للمحاولات التوسعية للمستعمرين، ووقفوا أمام الجرافات التي كانت تقلب الأرض وتغير ملامح المنطقة، إلا أن ذلك ربما يصبح غير ممكن في المستقبل القريب.
وتروي عالية كيف قضم المستعمرون الأرض وكيف يحاولون تقليد البدو في حياتهم، حين بدأوا برعي المواشي وبناء مساكن تشبه مساكن الرعاة، لاستغلال الأرض والسيطرة عليها.
“حدودهم الجديدة باتت وسط منازلنا”
في العمق تظهر المأساة الإنسانية التي تعيشها مئات العائلات الفلسطينية التي أصبحت تشهد قضم الأراضي داخل ساحات منازلها.
قبل 3 أشهر، أخذ سكان المليحات يروون حدود حياتهم الجديدة، وكيف أُغلق الأفق في وجوههم. ذاته محمد شاهد صورة قاتمة أمامه، عندما وصل المستعمرون إلى ساحات الحظائر ووضعوا حدودا جديدة للأرض التي سيطروا عليها.
ومن خلال تجميع علامات البؤس في صورة واحدة، يوقن عرب المليحات أنهم أمام أقسى فصل من فصول العزل والسيطرة التي يفرضها المستعمرون.
حربي أبو الكباش (50 عاما)، يروي تلك المأساة بكلمات بسيطة: “وُلدتُ هنا وعشتُ هنا وطُردتُ من هنا بعد 50 عاما”، وهو بذلك يشير إلى ما حل بخربة حمصة التي أُجبر جميع ساكنيها على الرحيل عنها.
تبدو محاولة استعادة الحياة بذكرياتها وماضيها مستحيلة في هذه الحرب التي يشنها المستعمرون المسلحون على التجمع، قبل الترحيل النهائي في عام 2022 شهد تجمع حمصة 7 موجات من الهدم الكلي، الذي نفذه جيش الاحتلال.
قال أحد المواطنين الذي عزف عن ذكر اسمه “أتذكر الخوف والبرد ومئات الذكريات الأخرى،ولا أتألم. أتذكر الترحيل ولا أحتمل”. لم يرغب هذا الرجل في ترك التجمع الرعوي الذي كان يسكن فيه لسنوات طويلة، لكن إلحاح زوجته وخوفها دفعاه إلى الرحيل خوفا من هجمات الاحتلال ومستعمريه.